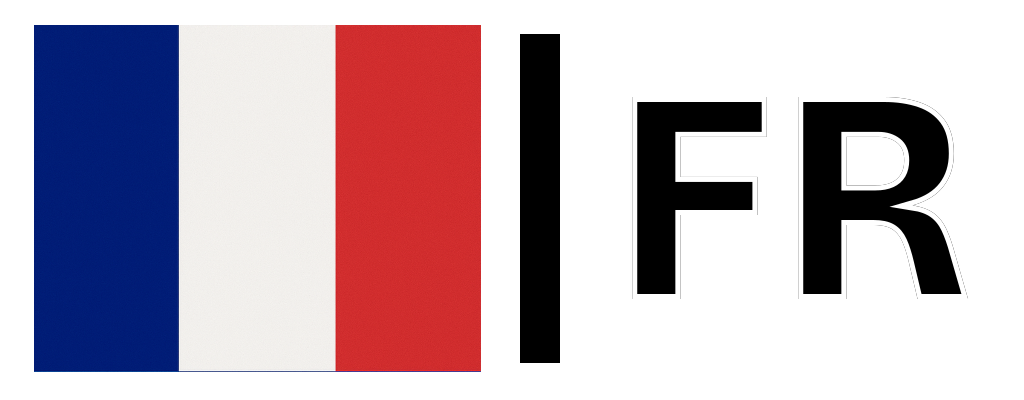- القدرة على احتجاز الكربون في الزرع المباشر بالمغرب: دراسة حالة لبرنامج "المثمر" للزرع المباشر
-
تم إنجاز هذه الدراسة بتعاون مع مركز الابتكار الفلاحي ونقل التكنولوجيا (AITTC-UM6P)، وتهدف إلى تقييم القدرة على احتجاز الكربون المرتبطة بزراعة القمح بنظام الزرع المباشر في 25 إقليماً مغربياً، اعتمادًا على منهجية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (GIEC). وقد أُنجز هذا التحليل في إطار برنامج "المثمر" للزرع المباشر، مستندًا إلى مساحة إجمالية تفوق 24,000 هكتار خلال الموسم الفلاحي 2022-2023، مع اعتماد مصادر بيانات متعددة لنمذجة دينامية الكربون العضوي في التربة وتقدير تطور مخزوناته عبر الزمن.
أظهرت النتائج وجود قدرة كبيرة لاحتجاز الكربون في الأنظمة المعتمدة على الزرع المباشر، وذلك عبر التراكم في مخزونات الكربون النشط والبطيء والسلبي. وتختلف هذه القدرة بشكل ملحوظ حسب الأقاليم، تبعاً للخصائص البيدو-مناخية المحلية. حيث سجلت المناطق الجبلية والرطبة، الأقل تعرضاً للحرارة المرتفعة، أعلى المعدلات، إذ بلغت على التوالي 0.96 طن كربون/هكتار و1.40 طن كربون/هكتار. في المقابل، أظهرت المناطق المتوسطة والهشة، التي تعاني من عجز مائي ودرجات حرارة مرتفعة، قدرات أقل بلغت حوالي 0.63 طن كربون/هكتار و0.86 طن كربون/هكتار
وتبيّن أن دمج مخلفات المحاصيل الزراعية في التربة عامل حاسم لتحسين احتجاز الكربون، حيث تساهم هذه الممارسة في تكوين الدبال، وتخزين الكربون، وتحسين بنية التربة، واحتباس الماء، وتنشيط الكائنات الحية الدقيقة، بالإضافة إلى الحد من تآكل المغذيات والمساهمة في تحسين المردودية الفلاحية على المدى الطويل.
ففي إقليم مكناس، الذي يُعتبر منطقة ذات إمكانيات عالية للزراعة الحافظة، يمكن لدمج 10% من مخلفات المحاصيل أن يحقق قدرة احتجاز تصل إلى 7.41 طن كربون/هكتار، بينما يؤدي دمج 50% إلى رفع هذا الرقم إلى 27.35 طن كربون/هكتار. ويتعاظم هذا الأثر بشكل أكبر في الترب التي تحتوي على نسب منخفضة من الرمال، مما يبرز أهمية الكسور الطينية والغَرَينية في تخزين الكربون.
وتُبرز هذه الدراسة تعقيد آليات احتجاز الكربون في السياق الفلاحي، وتؤكد على ضرورة اعتماد مقاربات سياقية تأخذ بعين الاعتبار الخصائص البيدو-مناخية وممارسات تدبير المخلفات الزراعية. ويُظهر زرع القمح المباشر قدرة كبيرة على التخفيف من آثار التغير المناخي، شريطة أن يتم إدماجه ضمن استراتيجية شاملة ومُكيّفة مع السياق المحلي.
- مقدمة
-
يعد المغرب، الذي يتميز بمناخ متوسطي، من بين البلدان الأكثر هشاشة في مواجهة التغيرات المناخية، والتي تتجلى أساساً في ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات السنوية والفصلية في التساقطات، فضلاً عن تكرار موجات الجفاف. ويزداد تأثير هذه التغيرات المناخية على مردودية المحاصيل الزراعية في المغرب، وخاصة الحبوب، سنة بعد سنة، مع شدة متزايدة بشكل طفيف.
من الناحية البيئية، تسببت الممارسات الزراعية التقليدية، وخصوصاً حرث التربة، في تدهور جودة التربة من خلال تسريع التعرية المائية والريحية، وانخفاض نسبة المادة العضوية في التربة. كما قد تسهم هذه الممارسات أيضاً في انبعاث الغازات الدفيئة المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.
أما من الجانب الاقتصادي، فإن الإنتاج الزراعي يواجه ارتفاعاً مستمراً في أسعار المدخلات الزراعية، خاصة الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف إنتاج المحاصيل.
وفي هذا السياق، ولمواجهة هذه التحديات، أصبح من الضروري إعادة التفكير في أنماط الإنتاج الزراعي، والتوجه نحو أنظمة زراعية مرنة ومستدامة، تهدف إلى الاستخدام الأمثل للمدخلات، واستقرار المردودية، والحفاظ على الموارد الطبيعية من تربة ومياه، والمساهمة في التخفيف من آثار التغير المناخي.
ومن بين أنظمة الإنتاج التي تقدم حلاً فعالاً ومستداماً لمواجهة تقلبات المناخ والتحديات الاقتصادية والبيئية المذكورة، يبرز نظام الزراعة الحافظة (Agriculture de Conservation).
وتُعتبر الزراعة الحافظة، التي تعارض الزراعة التقليدية القائمة على الحرث المكثف للتربة، بديلاً حقيقياً لتحسين ضعف الإنتاجية الزراعية والحد من تدهور الموارد الطبيعية مثل التربة والمياه.
وحسب منظمة الأغذية والزراعة (FAO) لسنة 2022، فإن الزراعة الحافظة هي نظام زراعي يعتمد على الحد الأدنى من اضطراب التربة (أي من دون حرث أو عبر الزرع المباشر)، والحفاظ على غطاء دائم للتربة، وتنويع الأنواع النباتية. ويُعزز هذا النظام التنوع البيولوجي والعمليات البيولوجية الطبيعية فوق سطح التربة وتحته، مما يُساهم في تحسين كفاءة استخدام المياه والعناصر الغذائية، والرفع المستدام من الإنتاج النباتي. كما أن الزراعة الحافظة تُعد مفهوماً يدعم الإدارة المستدامة للأراضي، وحماية البيئة، والتأقلم مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره.
- أصل وتاريخ الزرع المباشر
-
إن الحفاظ على الموارد الطبيعية ليس فكرة حديثة. فقد بدأ التحول من الزراعة التقليدية المعتمدة على الحرث إلى نوع آخر من الزراعة في ثلاثينيات القرن الماضي، وذلك بعد أزمة "الغبار الأسود" (Dust Bowl) التي ضربت المزارعين في منطقة الغرب الأوسط للولايات المتحدة، مما دفع المجتمع العلمي إلى إعادة التفكير في أوجه القصور في النظم الزراعية، وخصوصاً في مجال الحفاظ على التربة (Kassam et al, 2022).
وكان تقليل اضطراب التربة، إلى جانب استخدام بقايا المحاصيل كغطاء سطحي، خطوة هامة نحو فهم كيف يمكن الجمع بين هدف زيادة الإنتاج الزراعي والحفاظ على التربة والمياه في آنٍ واحد. وقد تأخر تطور هذا النظام واعتماده على المستوى العالمي بسبب عدة عوامل مُعيقة، من بينها التحكم في الأعشاب الضارة، وتطوير آلات الزرع المناسبة لظروف التربة والمناخ.
وقد انطلق فعلياً اعتماد نظام الزراعة الحافظة على الصعيد العالمي منذ تسعينيات القرن الماضي، ليصل إلى 205 ملايين هكتار بحلول سنة 2019، أي ما يعادل 14.7% من الأراضي الزراعية في العالم (Kassam et al, 2022)في المغرب، تم إدخال نظام الزرع المباشر، وهو أحد المبادئ الأساسية في الزراعة الحافظة، في أوائل ثمانينيات القرن الماضي في إطار شراكة بين المعهد الوطني للبحث الزراعي (INRA) ووكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID)، بهدف إنشاء مركز أبحاث في الزراعة الجافة بمدينة سطات.
وقد أظهرت البحوث التي قام بها باحثو المعهد في المناطق شبه القاحلة بالمغرب أهمية هذا النظام، سواء في الحفاظ على جودة التربة وتحسينها، أو في التخفيف من آثار الجفاف. كما أُجريت أبحاث إضافية في مناطق أخرى مثل منطقة زعير من طرف معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة (IAV Hassan II)، ومنطقة سايس من طرف المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس (ENA Meknès).
ورغم أن الأبحاث حول نظام الزرع المباشر انطلقت في أوائل الثمانينات، فإن تعميم هذه التكنولوجيا على نطاق واسع لم يبدأ إلا سنة 2015، مع تسارع كبير سنة 2020، إثر إطلاق المخطط الوطني للزرع المباشر سنة 2021، والذي يهدف إلى بلوغ مليون هكتار مزروع بهذه التقنية بحلول عام 2030.
وفي الواقع، شهدت المساحات المزروعة بهذه التقنية توسعاً سريعاً منذ ذلك الحين، لتبلغ حوالي 118 ألف هكتار خلال الموسم الفلاحي 2023-2024 (وزارة الفلاحة، 2024)
- مبادئ الزراعة الحافظة
-
تعتمد الزراعة الحافظة على ثلاثة مبادئ مترابطة، يتم تكييفها حسب الظروف والاحتياجات المحلية (منظمة الأغذية والزراعة –FAO، 2022) :
1. الحد الأدنى من التدخل الميكانيكي في التربة أي بدون القيام بأي عملية حرث للتربة، وذلك من خلال وضع البذور و/أو الأسمدة مباشرة (الزرع المباشر باستخدام آلة زرع خاصة).
2. تغطية عضوية دائمة للتربة بنسبة لا تقل عن 30% بواسطة بقايا النباتات أو محاصيل التغطية.
3. تنويع الأصناف النباتية من خلال دورات زراعية متنوعة وتداخلات تشمل على الأقل ثلاث أنواع مختلفة من المحاصيل.
ويجب أن تُدمج هذه المبادئ الثلاثة مع ممارسات زراعية جيدة أخرى، أبرزها التسميد المعقلن للمحاصيل الوقاية المتكاملة من الأعشاب الضارة، والأمراض، والآفات
- 1 - مزايا زراعية
-
يُساهم نظام الزراعة الحافظة في زيادة قدرة التربة على تخزين المياه وتحسين الحصائل المائية للحقول، وذلك من خلال تقليل فقدان المياه عبر التبخر وتحسين عملية تسربها داخل التربة. كما يُساهم هذا النظام في تقليص كمية البذور المستعملة، مما يُقلل من التنافس بين النباتات، ويُعزز قدرة المحاصيل على تحمل الإجهاد المائي، ويُحسّن كفاءة استخدام المياه في المناطق الجافة.
يساعد هذا النظام أيضاً على تقليص استخدام الأسمدة، خاصة النيتروجينية، على المدى المتوسط والبعيد، بفضل ارتفاع نسبة المادة العضوية في التربة.
كما يُساهم نظام الزراعة الحافظة في تحسين خصوبة التربة ونشاطها البيولوجي وبنيتها، وهو ما ينعكس إيجاباً على تغذية النباتات.
وبفضل هذه المزايا، يؤدي النظام إلى تحسين مردودية المحاصيل وكفاءة استعمال المياه. - 2 - مزايا بيئية
-
يساهم نظام الزراعة الحافظة في حماية التربة من التعرية المائية والريحية من خلال الغطاء الدائم للتربة بواسطة بقايا المحاصيل. كما تُساعد الزراعة الحافظة في تثبيت الكربون في التربة بفضل ارتفاع نسبة المادة العضوية، وتُساهم في تقليل انبعاث الغازات الدفيئة نتيجة انخفاض استعمال المدخلات، خاصة الطاقية منها.
وتُسهم كذلك في تعزيز التنوع البيولوجي للتربة. - 3 - مزايا اجتماعية ـ اقتصادية
-
يُوفر نظام الزراعة الحافظة عدة منافع سوسيو-اقتصادية، يمكن تلخيصها فيما يلي:
• تقليص تكاليف إعداد الأرض للزراعة نتيجة إلغاء عمليات الحرث وتحضير مهد البذور.
• خفض تكاليف شراء البذور بنسبة تتراوح بين 30% و35%.
• تحسين دخل الفلاحين ورفاههم.
• توفير الوقت الناتج عن إلغاء عمليات الحرث.
• تقليل الجهد البدني المبذول من طرف الفلاحين.
• خفض تكاليف اليد العاملة، خصوصاً في الضيعات الكبيرة.
• تقليص الاستثمار في معدات الحرث.
• إطالة عمر الجرار الفلاحي
- بذارة الزرع المباشر
-
تُعتبر المكننة من أهم مصادر التكاليف في الاستغلالات الفلاحية، لذلك فإن اختيار المعدات الزراعية واستراتيجية المكننة يؤثر بشكل مباشر على دخل الفلاحين، وأيضًا على ظروف عملهم وقدرتهم على تبني التقنيات الجديدة (ADA, 2016)
يكمن نجاح نظام الزرع المباشر، في إتقان عملية الزرع، وخاصةً اختيار آلة الزرع المناسبة، وضبطها، واستعمالها بشكل جيد.
وعلى عكس آلات الزرع المستعملة في النظام التقليدي، والتي تكون مخصصة للأراضي المحروثة والخالية من بقايا المحاصيل، تتميز آلات الزرع المباشر بقدرتها على وضع البذور والأسمدة في أخاديد مع أقل اضطراب ممكن للتربة، حتى في وجود بقايا نباتية.
كما يجب أن تُمكن آلة الزرع المباشر من التحكم الدقيق في جرعة وعمق الزرع.
وفقًا Bourarach, 2018))، فإن أهم المعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند التفكير في اقتناء آلة زرع مباشر هي كما يلي:
• القدرة على الزرع في الظروف المحلية (نوع وحالة التربة، ونوع وحالة الغطاء العضوي للتربة)؛
• القدرة على زرع المحاصيل المستهدفة (حبوب صغيرة أو كبيرة، الجرعات الدنيا والعليا، نوع نظام التوزيع)؛
• الخصائص الحجمية للآلة (عرض العمل، المسافة بين الخطوط (ثابتة أو قابلة للتعديل)، سعة خزان الأسمدة، وسعة خزان البذور)؛
• ملاءمة وزن الآلة مع قوة الجرار المتوفرة .
بشكل عام، تُعد معرفة خصائص الضيعة وأهداف الإنتاج واحتياجاتها (نوع المحاصيل، المساحات، أنظمة الإنتاج، نوع التربة، قدرة الجرار والمناخ) خطوة أساسية في اختيار آلة الزرع المباشر المناسبة.. - سلبيات وإيجابيات البذارات بالأقراص والبذارات المتقلبة
-
تُعد آلات الزرع المباشر ذات الشفرات وآلات الزرع ذات الأقراص من أكثر الأنواع استخدامًا في المغرب.
وسيُلخّص الجدول التالي أهم مزايا وعيوب كل نوع منهما:النوع العيوب المزايا آلات الزرع ذات الشفرات - اضطراب مفرط للتربة
- تفاوت في عمق الزرع
- صعوبة في التعامل مع بقايا المحاصيل الكثيفة
- تحريك بقايا المحاصيل
- مشاكل متكررة في انسداد الآلة
- صعود الحجارة إلى السطح
- تُساعد على نمو الأعشاب الضارة
- تتطلب قوة جر عالية نسبيًا
- جفاف مفرط لمنطقة الزرع- تُستخدم في جميع أنواع الأراضي
- آلة مدمجة ومحمولة على الجرار
- اختراق جيد للتربة
- تهوية جيدة للتربة
- وزن خفيف نسبيًا
- تتطلب صيانة بسيطة
- أقل حاجة للصيانة
- أكثر ملاءمة للزرع في الظروف الرطبة
- تكلفة أقل نسبيًاآلات الزرع ذات الأقراص - وزن أكبر نسبيًا
- قدرة اختراق غير كافية
- تحتاج صيانة متكررة للأجزاء الدوارة
- عدم إغلاق جيد للأخاديد في التربة الثقيلة
- غير ملائمة للأراضي الحجرية
- غير مناسبة للزرع في ظروف رطبة
- تكلفة أعلى نسبيًا- اضطراب طفيف للتربة
- أكثر ملاءمة في وجود كمية كبيرة من البقايا النباتية
- بقايا نباتية لا تتحرك كثيرًا
- تباعد أصغر بين الخطوط
- جفاف أقل في منطقة الزرع
- توزيع منتظم للبذور والأسمدة في التربة
- تحتاج إلى قوة جر أقلتُعد آلات الزرع المباشر ذات الشفرات الأكثر ملاءمة للظروف المغربية خلال مرحلة الانتقال من النظام الزراعي التقليدي إلى نظام الزرع المباشر، وذلك بفضل قدرتها على التكيف مع مختلف أنواع التربة والمحاصيل، وسهولة صيانتها واستعمالها، وتكلفتها المنخفضة نسبيًا.
ولتشجيع تبني نظام الزرع المباشر، قامت وزارة الفلاحة بإطلاق نظام تحفيزي لاقتناء آلات الزرع المباشر.
- تقنية الزرع المباشر في برنامج المثمر
-
أمام تزايد آثار التغيرات المناخية وندرة التساقطات المطرية، أصبح من الضروري استكشاف ونشر نماذج انتقالية زراعية بيئية على نطاق واسع، ترتكز على آليات متعددة ومتكاملة للتكيف.
وفي هذا الإطار، تم إطلاق برنامج "المثمر" سنة 2019، بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمعهد الوطني للبحث الزراعي (INRA)، وبدعم علمي من جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)
ويهدف برنامج "المثمر" إلى دعم المخطط الوطني للزرع المباشر، الذي يطمح إلى بلوغ مليون هكتار في أفق 2030، كما يعمل على تسريع اعتماد ممارسات الزراعة الحافظة لتعزيز مرونة الأنظمة الزراعية المغربية أمام آثار التغير المناخي.خلال الموسم الفلاحي 2023-2024، شمل البرنامج 32710 هكتارات من الزرع المباشر موزعة على 125 جماعة ترابية تابعة لـ 23 إقليماً، بمشاركة أكثر من 4.300 فلاح مستفيد، وتوزيع 68 آلة زرع مباشر لفائدة 70 تنظيم مهني شريك.
وقد توزعت المساحات المنجزة كما يلي:
₋ الحبوب: 92٪
₋ البقوليات: 4٪
₋ الزراعات الزيتية: 3٪
₋ الأعلاف: 1٪
وقد تم تنفيذ هذا الزخم من طرف فريق شاب ومتحمس من المهندسين الزراعيين العاملين في الميدان، الذين يلعبون دورًا محوريًا في مواكبة الفلاحين، وتحفيز الفاعلين المحليين، وبناء منظومة ابتكار شاملة.زرع منصة تطبيقية للزرع المباشر بإقليم خريبكة
ويعتمد البرنامج لتحقيق أهدافه على خطة عمل مندمجة يتم تنفيذها بتنسيق وثيق مع جميع المتدخلين المؤسساتيين والعلميين والمهنيين ;
الإجراء الهدف تشجيع اعتماد الممارسات الجيدة للزراعة الحافظة: الزرع المباشر، تدبير البقايا النباتية، وتنويع المزروعات اختيار وتنظيم جلسات تحسيسية للتنظيمات المهنية (OP) والفلاحين تعزيز قدرات الأعضاء وسائقي الجرارات في ما يخص ضبط، استعمال وصيانة آلات الزرع تكوين أعضاء وسائقي الجرارات التابعين للتنظيمات المهنية حول ضبط واستعمال وصيانة آلات الزرع الاستجابة للطلب المتزايد على المعدات ومواكبة توسيع البرنامج اقتناء وتوفير آلات زرع جديدة لفائدة التنظيمات المهنية الشريكة دعم حسن تنفيذ منصات التجريب وضمان نقل التكنولوجيا على مستوى الحقول المتابعة التقنية ومواكبة الفلاحين من طرف المهندسين الزراعيين الإقليميين تثمين النتائج المحققة وتحفيز انخراط المجتمعات الفلاحية المجاورة تنظيم عروض تطبيقية ومدارس حقلية حول منصات التجريب توسيع مجال التدخل ليشمل مناطق جديدة واعدة تحديد مناطق ذات إمكانات عالية وتنظيمات مهنية جديدة نشيطة تعبئة وتوحيد جهود الشركاء حول دينامية الزرع المباشر المشاركة في أيام تحسيسية بشراكة مع فاعلي القطاع إنتاج بيانات تقنية واقتصادية موثوقة لتقييم أداء النظام تركيب، تتبع وتحليل نتائج المنصات التطبيقية تثمين نتائج المنصات التطبيقية ، ضمان تقاسم المعرفة ورأسملة المكتسبات إعداد تقارير تقنية ومنشورات علمية الترويج ونشر مبادئ وفوائد الزرع المباشر إنتاج ونشر محتويات بيداغوجية ووسائط متعددة لفائدة مختلف الفئات: كبسولات فيديو، منشورات، برامج إذاعية، إلخ
- المنصات التطبيقية: الرؤية أساس الاقتناع
-
في إطار نهج تجريبي زراعي تشاركي، قام برنامج المثمر للزرع المباشر بإنشاء أكثر من 584 منصة تجريبية (PFD) في مختلف المناطق المغطاة، بهدف مقارنة موضوعية بين نظام الزرع المباشر والنظام التقليدي. وقد تم تركيب هذه المنصات في مناطق مختلفة مناخيًا وزراعيًا، مع اعتماد برامج زراعية متكاملة (ICP) تأخذ بعين الاعتبار التوصيات العلمية والخصوصيات الإيكولوجية المحلية.
يعتمد المسار التقني المعتمد في زراعة الحبوب على مقاربة إدارة متكاملة تهدف إلى:
.
1. تحسين استخدام المياه والمدخلات،
2. تنفيذ مكافحة متكاملة للأعشاب الضارة والأمراض والآفات،
3. تقليص تكاليف الإنتاج،
4. تعزيز استدامة النظم الزراعية،
5. الحد من التأثيرات البيئية السلبية على التربة، الماء، الهواء، التنوع البيولوجي.
تم تنفيذ الموسم الزراعي 2023-2024 في سياق مناخي صعب، اتسم بنقص حاد في التساقطات حتى شهر مارس. ومع ذلك، أظهرت القطع الزراعية المسيرة وفق نظام الزرع المباشر، مع استخدام معقلن للأسمدة الأساسية، مقاومة أفضل للإجهاد المائي في منتصف الدورة الزراعية. كما أن استئناف التساقطات خلال مارس (بأكثر من 80 ملم على المستوى الوطني) ساهم في استرجاع قوي لنمو المحاصيل، خصوصاً تلك التي تم زرعها بالزرع المباشر، والتي تمكنت من الوصول إلى مرحلة امتلاء الحبوب
في مختلف المناطق الزراعية والمناخية، أثبت نظام الزرع المباشر أداءً متفوقًا سواء من حيث الكتلة الحيوية أو إنتاج الحبوب، على الرغم من قصر مدة الدورة الزراعية والعجز المطري.
وقد مكنت الممارسات الزراعية الجيدة عبر برامج ICP ، إلى جانب تبني الزرع المباشر، من تأمين إنتاج الحبوب في العديد من الجهات.المنصة التطبيقية: الزرع المباشر مقابل الزرع العادي
على الصعيد الاقتصادي
مكن الزرع المباشر من خفض تكاليف الاستغلال بمعدل يتراوح بين 900 و1400 درهم للهكتار، وذلك بفضل إلغاء أعمال إعداد التربة وتقليص جرعات البذور
ويتيح هذا التوفير الأولي للفلاحين هامشاً أكبر للاستثمار، سواء في اقتناء المدخلات أو تنويع أنشطتهم الزراعية.على الصعيد التقني
أظهرت النتائج المسجلة على المستوى الوطني أن المردودية البيولوجية في المنصات التجريبية المعتمدة على الزرع المباشر قد ارتفعت بمعدل +21.5٪ مقارنة بالشواهد المحلية المعتمدة على النظام التقليدي.
أما من حيث مردودية الحبوب، فقد بلغ متوسط الزيادة +11.2٪، ما يؤكد النجاعة التقنية لهذا النظام الزراعي المبتكر في ظل الظروف المناخية المغربية.
منصة تطبيقية لتقنية الزرع المباشر بإقليم وزان
تؤكد الأبحاث المنجزة على المستويين الوطني والدولي أن الزرع المباشر يُعد أحد الركائز الأساسية للزراعة الحافظة
وتُعد النتائج المحققة من خلال منصات التجريب ضمن برنامج "المثمر" مشجعة للغاية، وينبغي أن تُحفّز كافة الفاعلين في القطاع الفلاحي، سواء العموميين أو الخواص، على تعزيز تنسيق جهودهم وتكثيفها من أجل تسريع تعميم هذا النظام على الصعيد الوطنيكما تُبرهن تجربة برنامج "المثمر" على أن الولوج المنظم إلى المعدات، وعلى رأسها آلات الزرع المباشر، مقترنًا بمقاربة تشاركية تعتمد على إشراك التنظيمات المهنية المحلية، يمثل رافعة فعالة لتوسيع المساحات المعتمدة على هذا النمط الزراعي.
ويُشكل التركيز على المناطق ذات المؤهلات العالية، مصحوبًا بمواكبة ميدانية قريبة وذات جودة، عاملاً حاسمًا في ترسيخ هذه الممارسات بشكل مستدام وضمان تبنيها على المدى البعيد